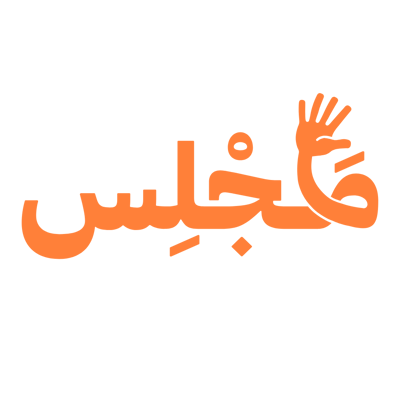مشهدٌ.. حانق
ثارت ثائرتُه.. وإلى أقصى ارتفاع يمكن أن يَصلُ إليه؛ أخذ يرفعُ كُلَ ما وقعت عليه يداه.. فلا يلبث إلا أن يقذف به.. وبأقصى ما يستطيع.. في اتجاه أيً مما وقع أمامه.. مُهاجماً كُلَ شيء وأيَّ شيء. صَاحبَ جميعَ ما سبق صوتٌ راعدٌ عالي.. يَهُزُ دواخلَ كُلَ من وقع على مسامعه. كلُ ذلك وقد خَلَّف بعده كثيرً من الدمار والأذى والخراب.. لكلِ ما وقع في طريقه وكان في أثره.
لو تساءلنا عن المشهد السابق، وحاولنا معرفة وفهم ما يحدث ومن ثمَ تَسمَّيَته، لن نكاد نجد رأيان لا يُجمِعان، على أن المشهد السابق يُجسد ثورة "غضب".
ثم هبَّ أنَّا زدَّنا على ذلك.. وحاولنا إنزال هذا المشهد وصاحِبهُ مَنزِلَ الحُكم، ووضعناه في ميزان الجيد من السيئ.. وسألنا مباشرةً: هل في هذا المشهد أيُ مُشكلة؟ لكانت الإجابة.. وعلى البداهة.. نعم.. وبمجرد الوقوف على تفاصيل متعددة من المشهد (الأذى المادي/النفسي، التخريب، إمكانية حدوث إصابات خطيرة إلى مميتة...) وذلك دون الحاجة لإطالة هذا المقال بسرد كافة العواقب التي من الممكن أن يُسببها ويُخلِفَّها الغضب.
الغضب.. مشكلة
هكذا.. وبهكذا بساطة.. تمت الإجابة على التساؤل الرئيس الذي عنّونَّ هذه المقالة، وخَلُصَّنَا إلى أن الغضب مشكلة.
يؤكد ذلك الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الخامس من ربع المُهلِكات، الربع المعني بتزكية النفس ورياضتها من مُهلِكَاتِها، من سلسة كتاب "إحياء علوم الدين". حيث يظهر ذلك التأكيد في تخصيص كتاب كامل عن ذَمِّ "الغضب"، وربطِ هذا الأخير بمُهلِكات أخرى تابعة وعواقب نفسية خطيرة.
فيَرى الغزالي أن الإنسان الغضوب الذي يَكثُر غضبه ويطول حدَّ الإفراط، لا يمكن إلا أن يحقد. والحقد هاهنا ثمرةُ الغضب ونتاجه، لتكمن الخطورة في أن الحقد نَفسُه مَهلكةٌ أنكَّى وأكبر من الغضب. ثُمَّ إن هذا الحقد سُرعان ما سيحملُ المرء على تمني الأذى لغريمِه فزوال النعمة عنه، مُحدِثاً مُهلِكةً أشدُّ وأكبر في النفس وهي الحسد، والذي وبذلك، يُعَدُّ ثمرة الحقد والغضب ونتاجهما أيضاً.
العجيب كذلك.. أن توغُّل هذه المُهلِكات في النفس لا يلبث إلا أن يكون لاحقاً جذور لمُهلِكات أشد وأعظم على النفس أيضاً، وهي العِجَبَّ والكِبَر. مُهلِكات من عظمتِها تسببت بطرد "إبليس" من الجنة بعد أن كان من المقربين.
بل إنَّ العِجَبَّ والكِبَر مُهلِكات هي أكثر خطورةً وتعقيداً بمراحل من سابِقاتِها لكل مُتبصِر، وذلك ابتداءً من صعوبة إدراكها ورصدها على الكثير، إلى حتى الوعي بها وحقيقة أنها تُحاك من الداخل وفي الداخل، ومن ثَمَّ العَزمَّ الجدِّي على الوقوف عليها، فرياضتها وتهذيبها في النفس.
كل ما سبق، هو غيضٌ من فيض من أثر الغضب الخفي ومعالُمه على القلب، والذي سلامتُه وتنقيتُه؛ الهدف من رياضة النفس وتَزكيتِها. وكُلُ ذلك دوناً عن أثرِ الغضب الظاهر على بقية الجوارح، كاللسان (انطلاقه بالشتم، الفحش من الكلام، اضطرابُ اللفظ...)، إلى بقية الأعضاء (الضرب، الأذى، التمزيق...)، كما ذكر الإمام في كتابِه وفصَّل، وكما رأينا في المشهد الذي اُستفتح به هذا المقال.
الغضب.. ضرورة
المثير للاهتمام أن الغزالي نفسُه في تَفصِيلِه لذَمِّ الغضب، وحقيقة كونهُ مشكلة ومُهلِكة تتطلب الرياضة والتهذيب، لم يتوانى عن ذكر ضرورة الغضب، بل التفصيل في جانب ضَرورَتِه للمرء، وبصورة تشريحية مُثرية لماهيةِ الغضب وتركيبته وحقيقة وجُوده في أصل تركيبة الإنسان.
فيقول الغزالي: "اعلم أن الله تعالى لمَّا خلق الحيوان مُعرضاً للفساد والموتان بأسباب في داخل بدنه وأسباب خارجة عنه؛ أنعم عليه بما يحميه عن الفساد ويدفع عنه الهلاك إلى أجلٍ معلوم سمَّاه في كتابه".
فذكر أن الأسباب التي قد تؤدي بالإنسان للهلاك والفساد، كالجوع؛ فالحاجة للطعام، وكالمأوى؛ فالحاجة للمسكن، وكالخوف من الأذى أو القتل والنهب؛ فالحاجة للدفاع والحماية والأمان... كُلُهَا أسباب حتماً تتطلب قوة باعثة تدفع الإنسان لرفع هذه الحاجات عنه، أو على الأقل تخفيف ألمها وألم مواجهتها بين حينٍ وآخر وقدر الاستطاعة.
لنجد هاهنا أن طبيعة الغضب قد خلقها الله من النار كقوة باعثة مُحرِكة، وغرزها في الإنسان وعجنها بطينَتِه (احمرار وجه الغاضب وعينيه وارتفاع حرارة جسمه وكأن دمه يغلي لحظة الغضب). كُلُ ذلك حتى في حُدوثِها يثور ويَحتَجّ الإنسان، إما سعياً وطلباً للطعام في حالة الجوع، أو طلباً لسقفٍ يُحيطُ به وبابٌ يُغلق عليه في حالة الخوف والحذر، فيأمن ويحتمي في مسكن، ويدفع عنه أي خطرٍ ممكن أن يصيبه. إلى غير ذلك من الأمور الغريزية أو الاعتيادية والتي من الممكن أو المحتمل أن تبعث على الغضب وتُحرِكُه وتتحرك به.
وكأننا هاهنا نرى الغضب كَلباس وغطاء للقُدرة؛ قدرة المرء على إشباع واحتواء الحاجات، وقدرتِه على نيل الرغبات واستحداثها. أو أن جزءً لا بأس به من مدى مقدرة الإنسان على التحرُك والعَيش والطلب والتغيير هو في عُمقِه مدفوعٌ بالغضب منوطٌ به.
بل إن الإمام ذكر على وجه التحديد أن عدم الغضب هو تفريطٌ بالغضب، وهو في حدّ ذاته حالة تُناقِض الحالة التي ذكرناها في إشكالية الغضب (حالة الإفراط في الغضب). وعرَّفَهُ على أنهٌ "فَقدُ هذه القوة أو ضَعفَها وهو الذي يُقال: إنهُ لا حمية لَهُ، وهو مذموم أيضاً"، شأنه شأن نقيضه الإفراط؛ والذي وصفهُ الغزالي في موضعٍ آخر بأنه "الغضب الذي يُخرج المرء عن سياسة العقل والدين وطاعتِه، ولا يبقى للمرء معه بصيرة ونظَر وفكرة ولا اختِيار، بل يَصيرُ فِي صورةِ المضطر".
إن ما ذكره الغزالي في كتابه عن ضرورة الغضب وحقيقة تركيبته، يتقاطع بصورة مُثيرة مع بعض ما ذكره "أفلاطون" بلسان أستاذه "سُقراط" في "الجمهورية" (جمهورية أفلاطونPlato's Republic )، والتي حاول فيها تعريف العدالة؛ بتعريف عدالة الدولة وربطها بعدالة الفرد، والخلُوص إلى مدينة مثالية فاضّلة تتحقق فيها تلك العدالة.
فيَذكُر أفلاطون أسطورة من الأساطير اليونانية، يُزعَم فيها أن الآلهة حين وزَّعت القوى على أنواع الحيوان المختلفة، لم تُبقِ للإنسان شيئاً من المواهب والقوى الطبيعية، إلا أن الإله بروميثيوس "حامي الإنسان وراعيه" سرق لهُ النار والفنون العملية (إشارةً للقوة الغضبية في نفس الإنسان)، وعلَّمَهُ كيف يستخدمها ويوظفها في الدفاع عن نفسه والبقاء.
حقيقةُ الغضب
ما سبق.. وعلى الضرورة.. يجعلنا نُراجِع إجابتنا الأولية على تساؤل المقالة الرئيس؛ وخُلوصِنا إلى أنَّ الغضب مشكلة، لنعود ونُجيب عليه: بأن الغضب في حقيقته مشكلة وضرورة معاً. والسِّر هو في الوقوف على تلك الـ"متى" المُصاحِبة لإجابتنا. أي الإجابة على وجه التحديد على تساؤلٍ جديد: متى يكون الغضب مشكلة؟ ومتى يكون ضرورة؟ والتفرقة الحتمية بينهما.
تعود لتُساعِدنا في التفرقة الأسطورة اليونانية التي ذكرناها مُسبقاً، فتذكر لنا أن القوة الغضبية والعملية وحدها لا تكفي الإنسان، لذلك وهبته الآلهة قوى ومعارف أخرى، وذلك بمعرفة العدالة والعفة لتنتظم حياته الاجتماعية وترتقي علاقاته ومدينته.
لنجد أفلاطون يَخلُص لاحقاً في "جمهوريته" لتعريف العدالة في الفرد على أنها ائتلاف ثلاث قوى في النفس، قوة شهوانية وقوة غضبية وقوة عقلية، يحكُم كل قوة بالتتابع فضيلة؛ العفة والشجاعة والحكمة. وأن العدالة في النفس تتحقق متى ما انتظم عمل هذه القوى بالتناغم سويةً؛ أي تَحَقُق العفة في القوة الشهوانية بخضوعها للقوة الغضبية وشجاعتُها (شجاعة تحصيل المأكل والمشرب والمسكن والتزاوج)، إلى ضرورة خضوع الأخيرة للقوة العاقلة (ضبط عملية التحصيل)، والتي تتوجَّه بمقتضى فضيلة الحكمة إلى الخير والعدل.
كذلك.. في التفرقة بين إشكالية الغضب وضرورته، سَطَّر لنا الغزالي أيضاً في كتابه قاعدة عجيبة ومنهجاً مُفصلاً دقيقاً للتفرقة. فرَبط بين الغضب والحب بصورة فريدة قائلاً: "ما بقي الإنسان يُحبُ شيئاً ويكرهُ شيئاً فلا يخلو من الغيظ والغضب، ما دام يُوافقُه شيءٌ ويُخالُفه آخر، فلا بد من أنَّ يُحب ما يُوافقُه ويكره ما يُخالُفه. والغضب يتبع ذلك، فإنَّه مهما أٌخِذَّ منه محبوبُه غَضِبَّ لا محالة، وإذا قُصِدَّ بمكروه غَضِبَّ لا محالة". أي متى ما عرفت ما تُحِبَّ أو تكرَهَّ، أدركت ما الذي يُمكن أن يُغضِبَك؛ سواءً كان ذلك في فَقدِ ما تُحِبَّ أو اقتِرابِ ما تكرَهَّ. وكذلك متى يكون الحب أو الكره هذا مشكلة، ومتى يكون ضرورة قد تؤدي للغضب.
يُساعدُنا الغزالي أيضاً في معرفة ذلك، بتَقسِيمه لما يُحبُه الإنسان إلى ثلاثة أقسام: أولها "ما هو ضرورة في حق الكافة كالقوت والمسكن والملبس وصحة البدن"، ثانيها "ما ليس ضرورياً لأحد من الخلق كالكثرة في الجاه والمال والصيت والتصدر في المجالس والمباهاة في العلم، وغيرها من الأمور التي صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور"، ثُمَّ إلى آخِرها "ما يكون ضرورياً في حق بعض الناس دون البعض كالكتاب مثلاً في حق العَالِم وكذلك أدوات الصناعات في حق المُكتسِب الذي لا يُمكنه التوصل إلى القُوت إلا بِها" وغيرها من الضرورات التي توافق أحوال معينة لبعض الناس دوناً عن بعض. ليُفَصِّل الغزالي لاحقاً عن طرق رياضة وتهذيب كل قسم، مُشيراً لمتى يكون كل قسم مشكلة تتطلب التوقف وامتلاكُ النفس عند الغضب، ومتى يكون ضرورة تتطلب الانتباه للغضب والعمل بمُقتضاه، كُلُ ذلك دون تغييب رياضة النفس وتهذيبها في كل قسم.
جميع ما سبق.. يُحتِمَّ علينا الامتنان للغضب والامتنان بِه، في كَونِه من أُعطياتِ الله العجيبة والتي أودَّعها الرحمن في الإنسان. والسعي لشُكر هذه النعمة حَقَّ شُكرِها، وذلك بفَهِم جميع ما سبق وإدَّراكِه حَقَّ إدَّراكِه. وبالتالي حُسن تَوظِيف الغضب واستعمالِه متى ما كان ضرورة، إلى ملازمة تهذيبه وريَاضَتِه في النفس، وكُلُ ذلك حتى لا يُصبح مشكلة ومَهَلَكة نفسية عظيمة ذات عواقب وخيِّمة مؤلمة على الإنسان وكافة ما يتعلق به.
المراجع:
كتاب ذم الغضب والحقد والحسد، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي
جمهورية أفلاطون، د.أميرة حلمي مطر
بقلم: أ. مشاعل النويصر
تحرير: مَجْلِس